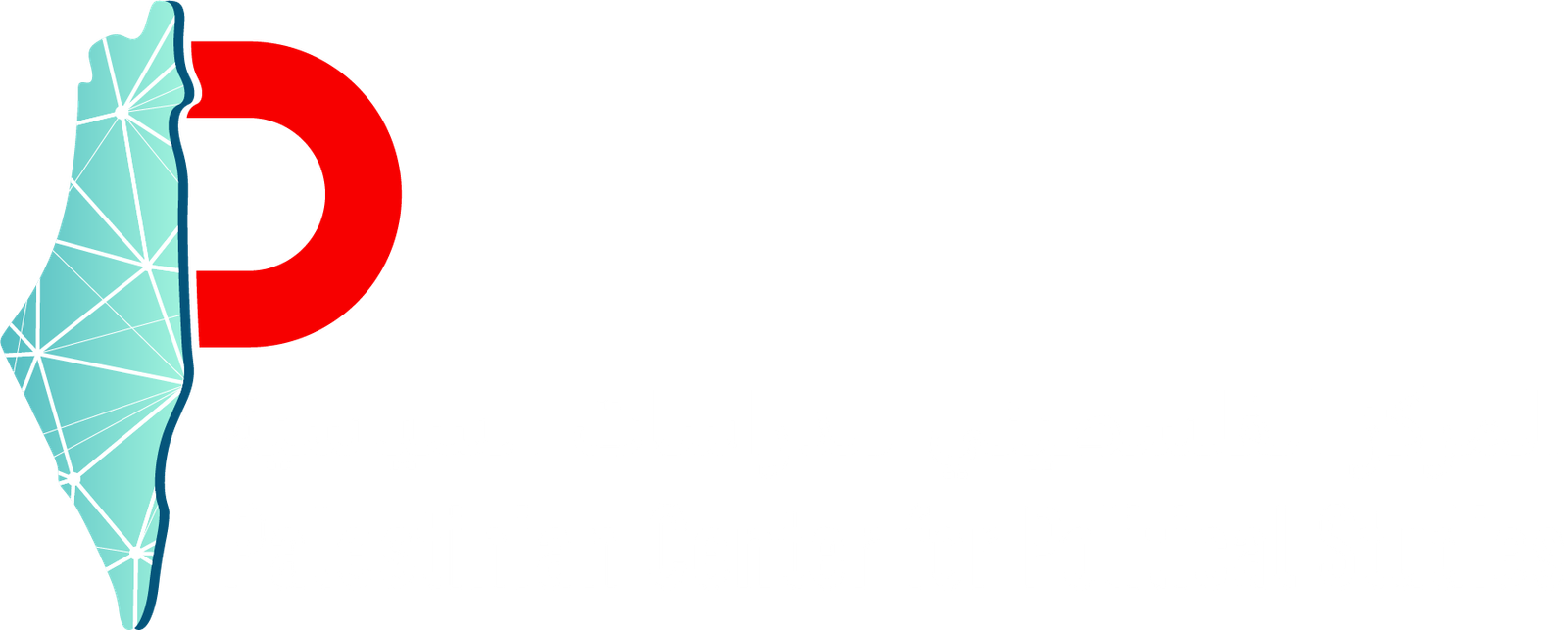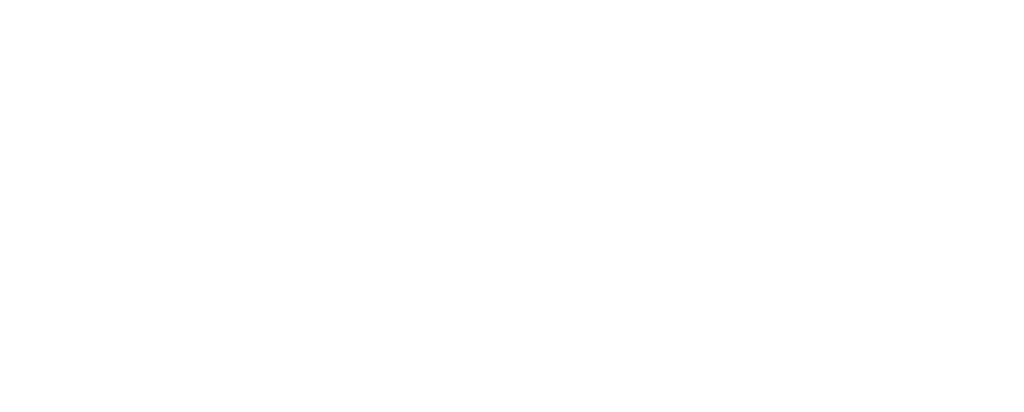مقدمة
تعرض قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إبادة غير مسبوقة في التاريخ الفلسطيني المعاصر، اتسمت باتساع نطاق الاستهداف، وارتفاع كثافة النيران، وشمولية التدمير، ليس فقط للبنية التحتية، بل للنسيج الاجتماعي والسكاني بمجمله.
لقد واجه المجتمع الغزي حربًا لم تُبقِ ولم تذر، استهدفت الإنسان والعائلة والمكان، فأُبيدت أحياء سكنية بأكملها، واستشهد عشرات الآلاف من المواطنين، وتشرّد أكثر من 85% من السكان، وتعرضت مؤسسات الرعاية والتعليم والصحة للتدمير الكلي أو الجزئي.
وإذا كانت آثار الحرب العسكرية والاقتصادية تحظى باهتمام نسبي في الخطاب العام، فإن التأثيرات الاجتماعية لا تزال في معظمها خارج دائرة التوثيق والتحليل العميق، رغم خطورتها طويلة الأمد، ومركّباتها النفسية والمجتمعية المعقدة، وانعكاسها المباشر على فرص التعافي وإعادة البناء.
تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على أبرز التأثيرات الاجتماعية الناجمة عن حرب الإبادة في غزة، وتحليل التحولات التي طرأت على بنية المجتمع، ونمط العلاقات، والهوية الجمعية، واستكشاف الأزمات النفسية والاجتماعية الجديدة، ومحدّدات الصمود والمقاومة المجتمعية، وصولًا إلى بلورة تصور أولي حول متطلبات التعافي الاجتماعي في مرحلة ما بعد الحرب.
أولًا: السمات العامة للتدمير المجتمعي خلال الحرب
تميزت حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بكونها حربًا شاملة ضد المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته، وليس فقط ضد البنية العسكرية أو البنية التحتية المادية، ويمكن إبراز السمات العامة لهذا التدمير المجتمعي في الجوانب الآتية:
- الاستهداف الممنهج للعائلات
مارس الاحتلال سياسة ممنهجة تقوم على استهداف العائلات بأكملها في منازلها، عبر قصف مباشر ودون سابق إنذار، وقد وثقت مؤسسات حقوقية ودولية استشهاد آلاف العائلات بأكملها، من الجد إلى الحفيد، في مشهد غير مسبوق من الإبادة العائلية، وتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن أكثر من 65% من الشهداء هم من النساء والأطفال، وهو ما يعكس الطابع الإبادي غير التمييزي للحرب. - تفكيك المجتمع عبر التهجير القسري المتكرر
فرضت الحرب على السكان موجات متعددة من التهجير القسري، شملت ما يزيد عن 85% من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون نازح)، اضطروا للتنقل من منطقة إلى أخرى تحت القصف، في ظروف غير إنسانية. هذا التهجير المتكرر فكك البنية الاجتماعية التقليدية، وأدى إلى تشتت العائلات، وتدمير الحواضن المجتمعية مثل الجيرة، والمدرسة، والحي، ومؤسسات الرعاية. - انهيار منظومة الخدمات الاجتماعية
استُهدفت بشكل مباشر المؤسسات الاجتماعية والخدمية من مدارس، وجامعات، ومساجد، ومراكز رعاية، ومراكز ذوي الإعاقة، ما أدى إلى انهيار المنظومة الاجتماعية المنظمة التي كانت تسند شرائح واسعة من المجتمع، خصوصًا الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. - قتل الطفولة وتدمير المستقبل
قُتل أكثر من 19 ألف طفل خلال الحرب، كثير منهم مع عائلاتهم كاملة، بينما يعاني عشرات الآلاف من إعاقات جسدية دائمة أو اضطرابات نفسية حادة، وتمثل هذه الحرب مجزرة ضد جيل كامل من الأطفال، بما يهدد مستقبل المجتمع الفلسطيني على المدى المتوسط والبعيد. - تهشيم الرموز المجتمعية وتعطيل الحراك الاجتماعي
استشهد مئات المعلمين والأطباء والأئمة والوجهاء المحليين، واستُهدفت الأسر المؤثرة والفاعلة في المجتمع، ما أدى إلى إضعاف القيادة المجتمعية التقليدية، وتراجع آليات ضبط النزاعات والتوجيه الاجتماعي، كما أُعيق التعليم الجامعي والمدرسي، وفُصل الشباب عن مصادر تمكينهم وبناء مستقبلهم. - محو ملامح الحياة الجماعية والثقافية
لم تقتصر عمليات التدمير على الأجساد والمباني، بل امتدت إلى الذاكرة الجمعية والهوية الثقافية للمجتمع الغزي، من خلال استهداف الأماكن العامة والأسواق الشعبية والمراكز الثقافية والرياضية، وحتى المقابر والمساجد ذات الرمزية التاريخية، كما تم تدمير أحياء كاملة كانت تمثل مشاهد مألوفة لحياة اجتماعية نشطة، بذلك سعى الاحتلال إلى تفكيك الصورة الجمعية للمجتمع، ومحو أي مظاهر للاستقرار أو الحياة المتوارثة، وهو ما يُعد ضربًا مباشرًا للبنية الرمزية والثقافية التي تحفظ تماسك المجتمع وتواصله التاريخي.
ثانيًا: أبرز التحولات الاجتماعية والنفسية في المجتمع الغزي خلال الحرب
تسببت حرب الإبادة في تغييرات عميقة وسريعة في البنية الاجتماعية والنفسية لسكان قطاع غزة، إذ أُجبر السكان على مواجهة مستويات غير مسبوقة من الفقد، والتهجير القسري، والعيش في ظروف لاإنسانية، ولم تؤدِّ هذه التحولات إلى صدمات فردية فحسب، بل أحدثت أيضًا خلخلة جماعية في الأنماط الاجتماعية التقليدية، وطبيعة العلاقات الأسرية، وأشكال التنظيم الاجتماعي.
- تفكك النسق الأسري وبروز أسر جديدة مشوهة
فقدان المعيل أو أحد الوالدين في مئات آلاف الأسر أدى إلى تفكك البنية التقليدية للأسرة الغزية، فقد سُجلت حالات متعددة لأطفال فقدوا كل أفراد أسرهم، وتحوّل بعض الأطفال إلى معيلين لأشقائهم، أو أُوكلت رعايتهم لأقارب بعيدين، وأفرز هذا الواقع نمطًا جديدًا من الأسر “المشوهة”، لا تستند إلى الروابط البيولوجية أو التربوية التقليدية، ما قد ينعكس سلبًا على التربية، والانضباط، والهوية النفسية للأطفال.
مثال وشاهد: تُقدّر التقارير الحقوقية عدد الأطفال الأيتام في غزة بعد الحرب بما يزيد عن 17,000 طفل، كثير منهم بلا مأوى أو رعاية منظمة. - اضطرابات نفسية جماعية واسعة النطاق
تعرض مئات آلاف السكان، وخصوصًا الأطفال والنساء، لصدمات نفسية متكررة بفعل القصف، وفقد الأحباب، والمعاناة اليومية في ظروف النزوح والمعيشة القاسية، وتؤكد تقارير صادرة عن منظمات دولية أن غالبية السكان يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، وحالات القلق الشديد، والاكتئاب، ونوبات الهلع.
شاهد: ذكرت منظمة “أنقذوا الأطفال” في أبريل 2024 أن أكثر من 90% من الأطفال في غزة يعانون من مشاكل نفسية حادة نتيجة الحرب. - تراجع منظومة الضبط الاجتماعي وازدياد السلوكيات الانفلاتية
أدى انهيار مؤسسات إنفاذ القانون، وتفكك الروابط المجتمعية، إلى تراجع ملحوظ في منظومة الضبط الاجتماعي، وازدياد حالات السلوكيات الانفلاتية في بعض مناطق النزوح، مثل السرقة، والتعدي، وانتشار الفوضى، ويُعزى ذلك إلى اليأس، والضغط النفسي، وغياب المرجعيات التقليدية، لا سيما في المخيمات غير المنظمة. - بروز نماذج جديدة من القيادة المجتمعية ومن المبادرات الأهلية
في مقابل الانهيار الرسمي، ظهرت مبادرات مجتمعية شعبية لملء الفراغ، سواء من خلال تنظيم الإغاثة، أو توفير الرعاية للمصابين والناجين، أو حتى ضمان الأمن في بعض المناطق، وبرزت شخصيات مجتمعية وأئمة ومربون ومثقفون بدور قيادي غير رسمي، ما يشير إلى ديناميكية مجتمعية قادرة على إعادة إنتاج نفسها في الأزمات.
شاهد: في حي الشجاعية، شكّل سكان الحي لجنة طوارئ أهلية تولت توزيع المياه، وضبط النزاعات، وتنسيق جهود الإغاثة بين الجهات المختلفة. - تحولات في علاقة الأفراد بالجماعة والمجتمع
في ظل التهجير الجماعي والانفصال القسري عن الحي والمكان، والعائلة، شهد كثير من الأفراد تفككًا في شعورهم بالانتماء للمجتمع المحلي، وخصوصًا لدى الأطفال والشباب، وتسببت هذه القطيعة المكانيّة والاجتماعية في مشاعر العزلة، وأضعفت بعض القيم الجمعية كالتكافل، مقابل بروز النزعات الفردية أو العائلية الضيقة في بعض البيئات.
“لم أعد أعرف من جاري ومن قريبي… الجميع في الخيام غرباء”، شهادة أحد النازحين من رفح في حديث لوسيلة إعلام. - تغيّر دور المرأة في ظل الحرب
أجبرت الحرب كثيرًا من النساء على أدوار جديدة في الإعالة، والتنقل، والتدبير داخل بيئة اللجوء، وبعض النساء أصبحن معيلات وحيدات لعائلات كبيرة، واضطررن للعمل أو تنظيم حياة الخيمة أو التواصل مع الجهات الإغاثية، ما ولّد تحديات نفسية وضغوطًا مجتمعية متزايدة، ولكن أيضًا مكّن بعضهن من تنمية حس القيادة والمسؤولية. - تأثير الحرب على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن
غالبًا ما يُهمل هذا المحور، لكنه شديد الأهمية، فهؤلاء كانوا الأكثر هشاشة في ظروف النزوح والمعاناة، إذ فقد كثير منهم الرعاية والخدمات الطبية والغذائية، وتدهورت حالتهم النفسية والجسدية، وغياب بنية حماية خاصة بهم يعمّق من أزمتهم الاجتماعية لاحقًا. - 8. التغيرات في أنماط التربية والتنشئة
بفعل القصف المستمر، والعيش في المخيمات، وغياب المدرسة، وانشغال الوالدين بالمأساة أو غيابهما، تغيّرت طرق التربية اليومية للأبناء، سواء من حيث المحتوى أو السلوك، وبات الأطفال أكثر عرضة للاكتساب غير الموجَّه للقيم، أو للانضواء خلف مشاعر الكراهية والغضب، دون احتواء نفسي تربوي.
ثالثًا: المتطلبات الاجتماعية والنفسية للتعافي
تمثّل عملية التعافي من حرب الإبادة على غزة مهمةً مركبة، تتجاوز الاحتياجات الإنسانية والإغاثية إلى ضرورة إعادة ترميم البنية النفسية والاجتماعية للأفراد والمجتمع، وبناء آليات استجابة شاملة وطويلة الأمد، ويمكن تلخيص أبرز المتطلبات على النحو الآتي:
- توفير الدعم النفسي المتخصص والمجتمعي
تتطلب الصدمة الجمعية التي أصابت المجتمع الغزي إنشاء برامج دعم نفسي جماعي وفردي، تتناسب مع السياق الثقافي والديني، وتستهدف كافة الفئات، لا سيما:
• الأطفال والشباب الذين فقدوا أهلهم أو شهدوا مشاهد القتل والدمار.
• النساء المعيلات والناجيات من المجازر.
• الأسرى المحررين والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة.
وينبغي تدريب مرشدين نفسيين من أبناء المجتمع المحلي، وتشجيع العلاج الجماعي وأساليب التفريغ الثقافي كالرسم، المسرح، والكتابة. - إعادة بناء العلاقات الاجتماعية والثقة الجماعية
أدّت الحرب إلى تآكل البنى الاجتماعية التقليدية، لذا فإن التعافي يتطلب:
• دعم المبادرات الشعبية لإعادة الروابط بين العائلات والنازحين.
• تنظيم فعاليات مجتمعية لإحياء الذاكرة الجمعية والشعور بالانتماء.
• إعادة الثقة بالمؤسسات المحلية والقيادات الأهلية من خلال الشفافية والمشاركة. - تمكين المرأة وتعزيز دورها في التعافي
يُعد تمكين النساء اللواتي تحمّلن أعباء مضاعفة أثناء الحرب جزءًا أساسيًا من عملية التعافي. ويشمل ذلك:
• توفير برامج تدريب وفرص عمل للنساء المعيلات.
• دعم مبادرات النساء في قيادة المبادرات المجتمعية.
• إنشاء مساحات آمنة للتعبير والمشاركة في صنع القرار المحلي. - إعادة إحياء المؤسسات الثقافية والتربوية
للتربية والثقافة دور محوري في التعافي، لا سيما للأطفال والمراهقين، وتشمل هذه العملية:
• ترميم المدارس والمراكز الثقافية وإعادة افتتاحها.
• دعم الأنشطة التربوية غير النظامية في المخيمات.
• إدراج مفاهيم الصمود والهوية الوطنية في البرامج التعليمية. - العدالة والمحاسبة كمدخل للتعافي
التعافي لا يمكن أن يكتمل دون تحقيق العدالة والمحاسبة للمجرمين، وإشعار الضحايا بأن تضحياتهم لم تذهب سدى، يشمل ذلك:
• توثيق الانتهاكات قانونيًا وحقوقيًا.
• تمكين الضحايا من إيصال روايتهم للعالم.
• الضغط لمحاسبة الاحتلال في المحافل الدولية، بما يعزز من الكرامة الجمعية. - مشاركة الناجين في تصميم برامج التعافي
• ضرورة إشراك الناجين والضحايا في صياغة البرامج النفسية والاجتماعية، لضمان أن تكون ملائمة لاحتياجاتهم الحقيقية.
• تشجيع التمكين الذاتي للضحايا وعدم حصرهم في دور المتلقّي للمساعدة. - التعافي المجتمعي في المخيمات ومناطق النزوح
• التركيز على احتياجات مئات الآلاف من السكان الذين يعيشون في ظروف نزوح قاسية وطويلة الأمد.
• تقديم دعم نفسي واجتماعي خاص للنازحين قسرًا، بما يشمل أطفال المخيمات الذين يعانون من اضطرابات النوم والسلوك. - دمج الفئات المهمّشة في برامج التعافي
• مثل كبار السن، وذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الهويات المهمشة اجتماعيًا.
• ضمان شمولية البرامج من حيث الفئة والنوع والاحتياجات الخاصة. - تعزيز آليات المواجهة المجتمعية (Community Coping Mechanisms)
• دعم النماذج المحلية للمساندة، مثل: “الجيران، الأئمة، لجان الإصلاح، الأنشطة الجماعية”، بوصفها روافع لتعزيز الصمود.
• توثيق ونشر قصص التكيّف الإيجابي لتعزيز الأمل وبناء نموذج فلسطيني أصيل في مقاومة الإبادة. - العمل على تخفيف مظاهر الغضب المجتمعي والانهيار القيمي
• معالجة آثار الغضب، والعنف، وفقدان المعايير، والفراغ النفسي.
• دمج مبادئ “الصحة النفسية المجتمعية” في المدارس والمساجد ومراكز الإيواء. - الربط بين التعافي والهوية الوطنية الفلسطينية
• استثمار التعافي النفسي في تعزيز الشعور بالانتماء والكرامة الوطنية.
• تحويل الألم الجمعي إلى طاقة مجتمعية فاعلة لبناء المستقبل، دون طمس الرواية الفلسطينية.
رابعًا: أولوية الدعم المجتمعي والنفسي في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار
- إعادة تعريف مفهوم الإغاثة
لم تعد المساعدات العينية والغذائية كافية في مواجهة كارثة بهذا الحجم، إذ يجب أن تشمل جهود الإغاثة مقومات الدعم النفسي والاجتماعي الجماعي، وتوفير بيئة إنسانية آمنة تساعد الضحايا على استعادة إحساسهم بالأمان والانتماء. - توطين الدعم النفسي ضمن الخطط الوطنية
ينبغي أن يكون الدعم النفسي والاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات إعادة الإعمار، تمامًا كما يتم التخطيط لإعادة بناء البيوت والبنية التحتية، ويتطلب ذلك وجود كوادر مدرّبة، ونظم متابعة، وأطر مؤسسية وطنية تعمل بمعايير مهنية وإنسانية. - بناء شبكات مجتمعية للرعاية النفسية
إن الرعاية النفسية لا تكون فعّالة إذا كانت مركزية فقط؛ بل يجب توزيعها من خلال إنشاء وحدات دعم داخل الأحياء، والمراكز المجتمعية، والمدارس، والمساجد، ومراكز الإيواء، مع التركيز على بناء قدرات الأخصائيين النفسيين المحليين. - إعادة إعمار الإنسان قبل الحجر
ليس من المجدي إعادة إعمار المنازل فقط، في ظل وجود آلاف الأطفال والنساء ممن فقدوا أسرهم أو تعرضوا لصدمات نفسية شديدة، لذلك، فإن إعادة الإعمار الناجعة تبدأ من ترميم الإنسان نفسيًا، واجتماعيًا، وتعليميًا، بالتوازي مع الجهد العمراني. - دعم برامج التمكين والنهضة المجتمعية
ينبغي أن تتضمن جهود الإغاثة برامج التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنازحين، حتى لا يظلوا في حالة اعتماد دائم على المساعدات، بل يصبحوا فاعلين في إعادة بناء مجتمعهم. - تنسيق الدعم النفسي مع الجهات الدولية والمحلية
وذلك من خلال التنسيق بين المؤسسات الدولية والمنظمات المحلية لتوحيد الجهود وتجنب التكرار، ووضع آليات شفافة للمراقبة والتقييم لضمان جودة الدعم وفعاليته. - حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء إعادة الإعمار
تأكيد ضرورة احترام حقوق الإنسان، وضمان عدم تكرار الانتهاكات خلال عمليات إعادة البناء، وضمان إشراك المجتمع المدني في مراقبة تنفيذ المشاريع ودعم المساءلة. - التعليم والتوعية كجزء من التعافي
إطلاق حملات توعية مجتمعية للتخفيف من وصمة العار المرتبطة بالصدمات النفسية، وتدريب المدرسين والعاملين في الحقل التربوي على التعامل مع الأطفال المتضررين نفسيًا. - دعم الصحة النفسية للكوادر العاملة في الإغاثة
تقديم برامج دعم نفسي للمتطوعين والعاملين في الخطوط الأمامية، لأنهم يتعرضون لضغوط نفسية عالية، وضمان قدرتهم على الاستمرار في تقديم الدعم دون انهيار نفسي. - تعزيز البنية القانونية والمؤسسية للدعم النفسي والاجتماعي
الدعوة لتطوير أطر تشريعية تدعم الصحة النفسية والاجتماعية كجزء من حقوق الإنسان، وتطوير سياسات وطنية واستراتيجيات طويلة الأمد لدعم هذا القطاع.
خلاصة
حرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة ولا يزال لم تكن مجرد مأساة عسكرية أو أزمة إنسانية، بل شكلت كارثة اجتماعية ونفسية عميقة تُعيد تشكيل النسيج المجتمعي بأكمله، والنتائج المدمرة للقتلى والجرحى، النزوح القسري، تدمير البنى التحتية، وانهيار المؤسسات، إلى جانب الانهيار الأخلاقي والاجتماعي، خلقت واقعًا جديدًا من التحديات التي تتجاوز مرحلة الحرب لتصل إلى مراحل التعافي والبناء المستدام.
إن استمرار الحرب والحصار الإسرائيلي والسياسات الممنهجة التي استهدفت تدمير القطاع وابتزاز سكانه، أدت إلى تفكيك الروابط الاجتماعية وزيادة العنف، مع تزايد معاناة الفئات الأضعف خصوصًا النساء والأطفال، الذين يشكلون عماد المجتمع الفلسطيني، وفي الوقت نفسه، برزت مظاهر صمود اجتماعي ونضالي ساهمت في الحفاظ على هوية المجتمع ووحدته الوطنية في مواجهة محاولات الاحتلال لتفتيته.
تعافي غزة يتطلب أكثر من إعادة بناء المباني، فهو يحتاج إلى إعادة بناء الإنسان نفسيًا واجتماعيًا، ودعم النساء والشباب والأطفال، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تحترم الحقوق الإنسانية وتدعم المصالحة الوطنية، ويظل إنهاء الحرب ورفع الحصار شرطًا أساسيًا لتحقيق أي استقرار أو تعافي فعلي.
هذه الورقة تؤكد أن مسار التعافي الاجتماعي والنفسي يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من عمليات إعادة الإعمار، مع دعم متكامل يضم الجهات المحلية والدولية، وسياسات تشريعية ومؤسساتية تضمن حماية حقوق الإنسان وكرامته، فبغياب ذلك، ستظل تداعيات الحرب تنعكس على الأجيال القادمة، مما يعرض مستقبل غزة ومستقبل القضية الفلسطينية برمتها للخطر.
توصيات
- العمل على إنهاء الحرب ورفع الحصار
• العمل على الضغط الدولي والمحلي لوقف الحرب ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وفتح المعابر بشكل دائم، وضمان حرية الحركة والتنقل للسكان والبضائع، كشرط أساسي لأي تعافي فعلي. - إعادة إعمار شامل ومتكامل
• إطلاق مشاريع إعادة إعمار شاملة للبنية التحتية المدنية، مع إعطاء الأولوية للإسكان، التعليم، والمرافق الصحية.
• ضمان إشراك المجتمع المحلي في التخطيط والتنفيذ، وتوفير فرص عمل للشباب في مشاريع الإعمار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. - تعزيز الخدمات الصحية والنفسية
• إنشاء مراكز صحية ونفسية متنقلة في المناطق المتضررة، مع تدريب الكوادر الطبية والاجتماعية على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي المتخصص.
• إطلاق حملات توعية مجتمعية لتعزيز أهمية الصحة النفسية والتصدي لوصمة العار المرتبطة بالاضطرابات النفسية. - دعم النساء والفتيات
• تأسيس برامج دعم نفسي واجتماعي خاصة بالنساء والفتيات، مع توفير ملاجئ آمنة تحفظ كرامتهن وخصوصيتهن.
• تعزيز مشاركة النساء في لجان إعادة الإعمار وصنع القرار بما يضمن تمثيلًا عادلاً لمنظور النوع الاجتماعي. - حماية الأطفال ورعايتهم
• تسجيل ومتابعة حالات الأطفال الأيتام والمصابين، وتوفير الدعم النفسي، التعليمي، والاجتماعي المستدام لهم.
• توفير بيئة تعليمية آمنة بديلة خلال إعادة بناء المؤسسات التعليمية. - تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي
• دعم عمليات المصالحة الفلسطينية وتوحيد المؤسسات الوطنية لتنسيق الجهود نحو التعافي وإعادة البناء.
• تشجيع برامج التوعية التي تعزز الانتماء الوطني والقيم المشتركة، وتقلل من النزعات القبلية والانقسامات. - تطوير أُطر مؤسسية وتشريعية
• صياغة قوانين وسياسات وطنية تدعم الصحة النفسية والاجتماعية كجزء من حقوق الإنسان.
• إنشاء آليات مراقبة ومساءلة تضمن شفافية تنفيذ برامج التعافي والإعمار. - تنسيق الدعم الدولي والمحلي
• تأسيس منصة مشتركة تجمع المانحين، المنظمات الدولية، والجهات المحلية لتنسيق الموارد وضمان تحقيق أثر مستدام.
• تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج ودعم المستفيدين. - دعم الكوادر العاملة في المجال الإنساني
• توفير برامج دعم نفسي وعلاج لضغط العمل للمتطوعين والعاملين في القطاع الإنساني لضمان استمرار تقديم الدعم بكفاءة.