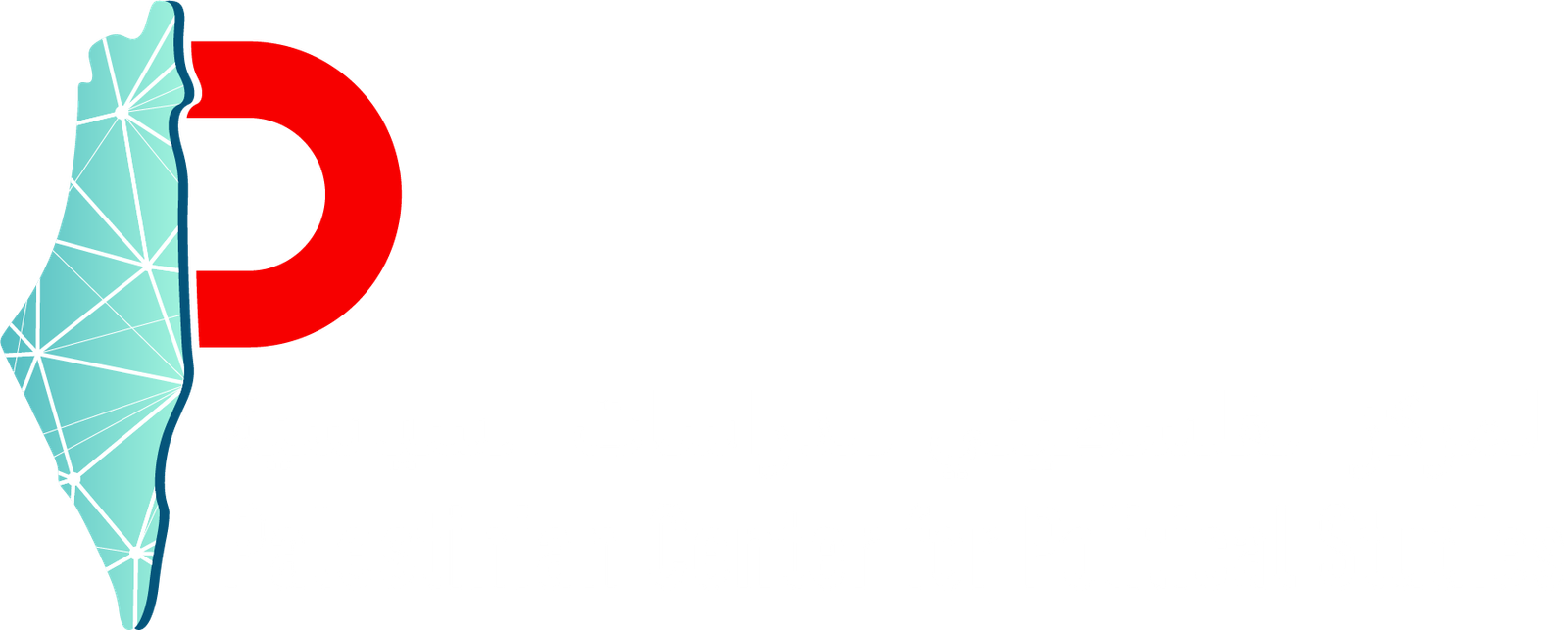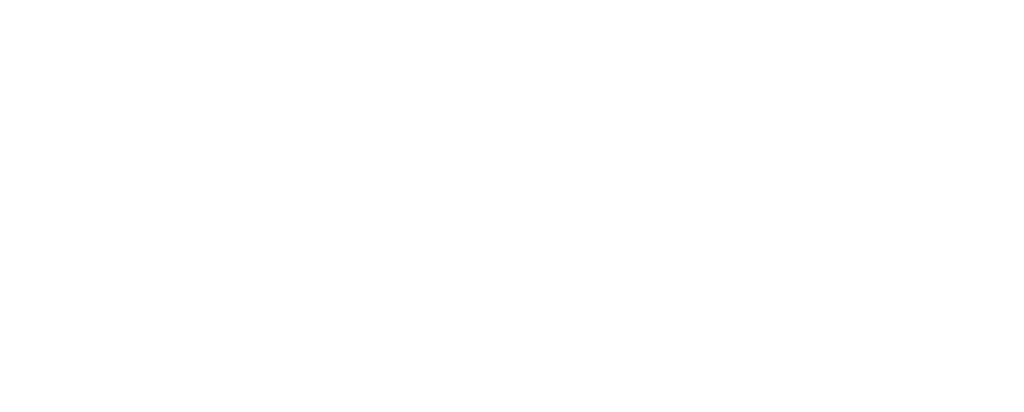قراءة تحليلية في الأبعاد السياسية والاستراتيجية
تحليل استراتيجي-المركز الفلسطيني للدراسات السياسية
مقدمة
تُعدّ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة لعام 2025، والتي طُرحت في خضمّ الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، واحدة من أبرز المبادرات السياسية الأميركية التي تعكس التحوّل في مقاربة واشنطن للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، من سياسة “الوساطة التقليدية” إلى نهج “إدارة الصراع وفرض التسويات”.
فالخطة لا تأتي في سياقٍ سياسي طبيعي، بل في ظلّ حرب إبادة واسعة النطاق يشنّها الكيان الإسرائيلي على القطاع، وانهيار شبه كامل في النظام الإنساني، وانكشاف فشل المنظومة الدولية في حماية المواطنين العُزل أو وقف العدوان، ما يجعلها محاولة لتوظيف المأساة الإنسانية الكبرى في غزة لإعادة هندسة الواقع السياسي الفلسطيني، وتثبيت هيمنة الكيان الإسرائيلي كأمر واقع جديد تحت غطاء أميركي دولي.
تسعى هذه الورقة إلى تحليل خطة ترامب 2025 من منظور سياسي واستراتيجي شامل، من خلال تفكيك مكوناتها الظاهرة والخفية، وقراءة أهدافها الفعلية في ضوء السياق الدولي والإقليمي الراهن، وموازين القوى الميدانية والسياسية. كما تستعرض الورقة انعكاسات الخطة على مستقبل القضية الفلسطينية، وتناقش أبعادها في ضوء استمرار الحرب على غزة، ومحاولات إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني، وتطويع الإقليم لخدمة الرؤية الإسرائيلية – الأميركية الجديدة.
أولًا: الخلفية التاريخية والسياسية – من صفقة القرن إلى خطة ترامب 2025
من الصعب فهم خطة ترامب الجديدة دون العودة إلى “صفقة القرن “التي طرحها في يناير 2020، وكانت تلك الصفقة تمثل أخطر محاولة أمريكية لإعادة تعريف القضية الفلسطينية وفق رؤية أمنية – اقتصادية خالصة، تقوم على:
- إضفاء الشرعية على السيطرة الإسرائيلية على القدس والمستوطنات.
- إسقاط حق العودة عمليًا.
- ربط “السلام الاقتصادي” بتطبيع العلاقات العربية – الإسرائيلية.
- تقليص دور السلطة الفلسطينية إلى إدارة مدنية محدودة في مناطق محددة من الضفة الغربية.
لم تُنفّذ الصفقة حينها بسبب الرفض الفلسطيني الواسع، واندلاع تحولات إقليمية وأمنية (كجائحة كورونا، وتغير الإدارة الأمريكية)، لكنها بقيت مرجعًا ضمنيًا للسياسات الإسرائيلية والأمريكية في التعامل مع غزة والضفة والقدس.
ومع اندلاع حرب طوفان الأقصى في أكتوبر 2023، وما تبعها من حرب إبادة إسرائيلية في غزة، أعادت الولايات المتحدة النظر في أدوات إدارتها للصراع، وبينما ركزت إدارة بايدن على “الاحتواء الإنساني” وتثبيت الهدن المؤقتة، عادت شخصيات محافظة في واشنطن – وفي مقدمتها الرئيس ترامب ومستشاروه السابقون – إلى الدفع باتجاه رؤية أكثر وضوحًا عنوانها “وقف الحرب مقابل إعادة تشكيل الوضع الفلسطيني”.
- التحولات التي مهّدت لعودة الخطة
يمكن تحديد جملة من التحولات التي مهدت لطرح “خطة ترامب 2025”:
- إسرائيليًا: فشل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق “نصر حاسم” في غزة، واتساع المعارضة الداخلية، وتآكل صورة الجيش، كلها عوامل دفعت تل أبيب إلى البحث عن مخرج سياسي مغطى دوليًا.
- أمريكيًا : رغبة ترامب في استعادة زمام المبادرة الشرق أوسطية كجزء من رؤيته الخاصة وعناصر شخصيته، عبر تقديم نفسه كـ“رجل الصفقات” القادر على وقف الحرب وإطلاق الأسرى.
- إقليميًا: تعاظم دور الوسطاء (مصر، قطر، وتركيا) في إدارة الهدن، وتزايد الضغوط الإنسانية والاقتصادية على غزة، ما وفّر بيئة مناسبة لطرح خطة “إدارة الأزمة”.
- فلسطينيًا: تواصل الحرب واستمرار سقوط الآلاف من الضحايا (شهداء وجرحى) واستمرار الانقسام الداخلي بين الضفة وغزة، مما يمهد للتعاطي الإيجابي مع الخطة أو على الأقل بشكل نسبي.
2. ملامح الاستمرارية بين الخطة الجديدة و”صفقة القرن”
رغم أن ترامب قدّم خطته بوصفها “مبادرة إنسانية لإنهاء معاناة غزة”، إلا أن القراءة التحليلية تكشف عن خيط استراتيجي يربطها مباشرة بصفقة القرن، يتمثل في:
- إعادة صياغة الحل على أساس إدارة الأزمة لا إنهائها، أي الانتقال من مشروع “حل نهائي” إلى “ترتيبات مؤقتة قابلة للدوام”.
- تجزئة الملف الفلسطيني: تركيز الخطة على غزة والأسرى وتدفق المساعدات، مع تغييب قضايا القدس واللاجئين والحدود.
- تطويع البعد الإنساني لخدمة هدف سياسي: جعل المساعدات والإفراج عن الأسرى أدوات ضغط لتأمين القبول الفلسطيني بترتيبات جديدة.
- الرهان على الأطراف العربية كوسطاء إداريين وليس شركاء سياسيين، لتخفيف الكلفة المباشرة على واشنطن وتل أبيب.
3. السياق الزمني والسياسي للطرح
طُرحت الخطة في أكتوبر 2025، بعد أشهر من جمود مفاوضات وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال، وتزايد الانتقادات الدولية للجرائم الإسرائيلية، وقد رافق إعلان ترامب حملة إعلامية مكثفة ركزت على “وقف النار” و“الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة”، باعتبارهما مدخلين لإنهاء الحرب، فيما تجاهلت الخطاب الحقوقي والسيادي الفلسطيني.
وفق تقارير صحفية (نيويورك تايمز، رويترز، الجزيرة، أكتوبر 2025)، تضمنت الخطة الأمريكية تصورًا أوليًا لثلاث مراحل:
- هدنة إنسانية قابلة للتجديد، مع مراقبة أمريكية – عربية.
- إطلاق متبادل للأسرى والمحتجزين بإشراف مباشر من واشنطن.
- بدء ترتيبات سياسية جديدة في غزة بإشراف إقليمي.
لكن مضمون الخطة في جوهره يتجاوز الجانب الإنساني، إذ يحمل نَفَسًا سياسيًا يعيد تعريف المشهد الفلسطيني من خلال إعادة ترتيب السلطة في غزة، وإضعاف المقاومة، وتثبيت مكاسب الكيان الإسرائيلي الميدانية ضمن اتفاقات مؤقتة.
ثانيًا: السياق العام لخطة ترامب 2025 – البيئة الدولية والدوافع الأميركية والإسرائيلية
تأتي خطة ترامب الجديدة في لحظة سياسية بالغة التعقيد إقليميًا ودوليًا، حيث تتقاطع فيها الاعتبارات الأميركية مع التحولات الجذرية التي أحدثتها حرب طوفان الأقصى في النظامين الإقليمي والدولي.
إذ لم تعد واشنطن تتعامل مع الحرب في غزة باعتبارها مجرد جولة عسكرية إسرائيلية، بل كأزمة استراتيجية تهدد مكانة الولايات المتحدة ومصالحها في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الانتقادات العالمية، وتراجع صورة الكيان الإسرائيلي، وانكشاف عجزه عن تحقيق نصر عسكري واضح بعد عامين من القتال.
- السياق الدولي: إعادة تموضع أميركا في النظام العالمي
منذ اندلاع الحرب على غزة، واجهت الولايات المتحدة ضغوطًا غير مسبوقة في ثلاث دوائر رئيسة:
- الشرعية الأخلاقية : إذ فشلت واشنطن في تبرير دعمها المطلق للكيان الإسرائيلي أمام الرأي العام العالمي، الذي يرى في الحرب جريمة إبادة ممنهجة، وقد عبّر عن ذلك عدد من القادة والمسؤولين الدوليين، من بينهم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي وصف ما يجري في غزة والضفة بأنه “فظائع تُرتكب في ظل إفلات تام من العقاب”، ما شكّل إحراجًا بالغًا للسياسة الأميركية.
- التحولات في النظام الدولي : في ظلّ تصاعد المنافسة بين واشنطن وكلٍّ من موسكو وبكين، تحوّل الصراع في غزة إلى ساحة اختبار لإرادة القوى الكبرى، حيث تدعم روسيا والصين خطابًا مضادًا للهيمنة الأميركية، وتقدمان نفسيهما كقوتين مناصرتين للعدالة الدولية وحق الشعوب في المقاومة.
- تراجع الهيمنة الغربية: مع انكشاف التواطؤ الأوروبي في دعم العدوان، وتزايد الأصوات المعارضة داخل الاتحاد الأوروبي، برزت مؤشرات على تحوّل المزاج الدولي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، كما ظهر في مواقف دول مثل إيرلندا وإسبانيا والنرويج، إضافة إلى مواقف مؤسسات دينية كالفاتيكان التي عبّرت عن رفضها الأخلاقي الصريح للجرائم في غزة.
في ضوء هذه البيئة، تسعى الإدارة الأميركية إلى إعادة تدوير دورها كوسيط دولي عبر مبادرة سياسية جديدة تمنحها مظهر “المنقذ الإنساني”، وتخفف من وطأة صورتها كطرف منحاز في حرب الإبادة، ومن هنا جاءت خطة ترامب بصيغتها الجديدة.
2. السياق الإقليمي: أزمات ما بعد الحرب وتبدّل المعادلات
على المستوى الإقليمي، تشهد المنطقة تحولات عميقة بفعل تداعيات الحرب الممتدة:
- تآكل منظومة التطبيع : فقد تراجعت موجة “اتفاقات أبراهام” بعد أن اصطدمت بواقع الجرائم الإسرائيلية في غزة، ما جعل الأنظمة المطبّعة تواجه ضغطًا شعبيًا وأخلاقيًا هائلًا، وفرض على بعضها إعادة حساباته، كما هو الحال في المغرب والإمارات.
- تصاعد الدور المصري: إذ وجدت القاهرة نفسها في قلب المعادلة الجغرافية والإنسانية، بين إدارة المعابر ومخاوف التهجير ومشروعات إعادة الإعمار، لذلك تسعى واشنطن إلى إغراء مصر بدور إداري وأمني مباشر في “منطقة الإيواء الآمنة” جنوب القطاع.
- التحرك السعودي المشروط: تحاول الإدارة الأميركية استدراج السعودية للانخراط في الخطة عبر وعود بإحياء مسار التطبيع مقابل “رعاية عربية لإعادة إعمار غزة”، لكنها تصطدم بموقف سعودي حذر يربط أي خطوة بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
تلك المعطيات جعلت من الخطة الأميركية محاولة لتطويق آثار الفشل العسكري الإسرائيلي، عبر إعادة توجيه دفة الأحداث نحو مسار سياسي “منضبط“ تُديره واشنطن، وتُشارك فيه أطراف عربية تحت شعار “إعادة الاستقرار إلى غزة”.
3. الدوافع الأميركية: من الاحتواء إلى فرض الوقائع
تستند خطة ترامب إلى مجموعة من الدوافع الاستراتيجية التي تتجاوز الجانب الإنساني المعلن، أبرزها:
- احتواء تداعيات الفشل الإسرائيلي: حيث تخشى واشنطن أن يؤدي استمرار الحرب واستنزاف الجيش الإسرائيلي إلى تفكك الردع الإسرائيلي وتراجع مكانته الإقليمية، بما يُضعف الركيزة الأساسية للمشروع الأميركي في الشرق الأوسط.
- استعادة زمام المبادرة السياسية: بعدما فقدت واشنطن السيطرة على إيقاع الحرب لصالح الميدان، تسعى الخطة إلى نقل الصراع من الميدان إلى الطاولة السياسية، بما يتيح لها إعادة توجيه مخرجات الحرب بما يخدم مصالحها.
- تجميل الصورة الأميركية: عبر تبني خطاب “إنساني” يدعو لإنهاء المعاناة في غزة، وهو ما يتيح للإدارة الأميركية امتصاص الانتقادات الدولية المتصاعدة واحتواء التململ داخل الحزب الديمقراطي المنافس للحزب الجمهوري الاكم، والشارع الأميركي.
- تعزيز شخصية ترامب: إذ تُظهر ترامب بمظهر “الرجل القادر على إنهاء الحروب وإعادة الاستقرار”، في مواجهة منافسيه الذين يُتهمون بالعجز والتردد.
4. الدوافع الإسرائيلية: تحويل الحرب إلى تسوية قسرية
من الجانب الإسرائيلي، تمثل الخطة الأميركية فرصة نادرة لتكريس المكاسب الميدانية والسياسية التي حققتها الحرب، ولو جزئيًا، من خلال:
- تحويل السيطرة الميدانية إلى مكسب سياسي دائم، عبر إعادة رسم خريطة القطاع بما يضمن للكيان الإسرائيلي عمقًا أمنيًا جديدًا في الجنوب والشمال.
- تدويل “عبء غزة“ بحيث تتحمل أطراف دولية وعربية مسؤولية الإدارة والإعمار، بينما يبقى الكيان الإسرائيلي متحكمًا في الأمن والحدود دون تحمل مسؤوليات الاحتلال القانونية.
- إمكانية إخراج المقاومة من المعادلة، سواء من خلال التهجير القسري، أو عبر ترتيبات أمنية تفرض نزع السلاح مقابل الإعمار.
- إعادة تأهيل الكيان الإسرائيلي سياسيًا، بإظهاره كشريك في حلّ “إنساني” تدعمه الولايات المتحدة، بعد أن تلطخت صورته عالميًا بمشاهد الدمار والإبادة.
يُظهر هذا السياق أن خطة ترامب 2025 ليست مبادرة سلام بالمعنى التقليدي، بل خطة إعادة هندسة للصراع تهدف إلى إنتاج واقع سياسي جديد في غزة يُلغي آثار طوفان الأقصى، ويعيد تعريف “القضية الفلسطينية” على أساس إنساني – إداري – أمني، يخدم الرؤية الإسرائيلية طويلة المدى.
ثالثًا: محاور الخطة ومضامينها السياسية -العسكرية – الإنسانية
- الشكل العام للخطة ومخططها البنيوي
تقدم خطة ترامب (المعلنة في أواخر سبتمبر/أكتوبر 2025) إطارًا ثلاثي المحاور: (أ) هدنة فورية وإطلاق أسرى/محتجزين، (ب) إجراءات أمنية لشل قدرة الفصائل، (ج) ترتيبات إدارية وإنسانية لإعادة الإعمار وإدارة غزة بصورة مؤقتة بإشراف دولي/إقليمي، وهذه الصيغة الهيكلية وردت بوضوح في التغطيات الدولية لطرح الخطة ومفاوضات الوساطة التي تلتها.
2. البنود العملية الأبرز (ما أعلنته الخطة)
- وقف فوري للأعمال الحربية مع “تجميد خطوط المواجهة” كشرط لبدء تنفيذ البنود الأخرى.
- آلية فورية لإطلاق الأسرى/الرهائن: الخطة نصّت على إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين خلال مهلة قصيرة (تم تحديدها إعلاميًا بـ72 ساعة في الصيغ المتداولة) مقابل إطلاق مكافئ لأعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى الكيان الإسرائيلي (الحديث عن أرقام مثل 250 محكوماً مدى و1,700 معتقلاً من أحداث 7 أكتوبر وما بعدها)، وهو بند مركزي استخدم كحافز للتفاوض.
- تفكيك البنية العسكرية للمقاومة: بند يطالب بنزع السلاح أو نزع القدرة الهجومية (أنفاق، صواريخ، بنى تحتية) كجزء من الفقرة الأمنية في الخطة، مع إقامة آليات مراقبة دولية.
- ترتيبات إدارية مؤقتة وإعادة إعمار: فتح معابر وإدخال مساعدات وإقامة هيئات إشراف إقليمية/دولية لإعادة إعمار القطاع، وتقديم حوافز اقتصادية وسياسات إعادة تأهيل.
3. الأهداف السياسية الخفية (القراءة الاستراتيجية)
- تحويل واقع الحلبة الميدانية إلى واقع سياسي: الخطة لا تسعى فقط لتهدئة مؤقتة، بل لشرعنة إعادة ترتيب إداري وسياسي في غزة يغيّر معالم السلطة والتمثيل، ويضع مؤسسات بديلة أو معدلة تحت رقابة إقليمية ودولية. هذا الهدف يجعل من “الإغاثة” وسيلة لتحقيق أهداف سياسية.
- استخدام ملف الأسرى كورقة ضاغطة: مقايضة الأسرى تُستخدم كأداة لامتصاص الغضب الداخلي في الكيان الإسرائيلي وكغطاء لانسحابات ميدانية محددة أو تغييرات إدارية في القطاع.
- تفكيك البعدين العسكري والسياسي للمقاومة دون مواجهة دولية مباشرة: عبر تفويض مهام أمنية وإدارية لأطراف ثالثة (مصر، قطر، دول غربية) تُخفف الضغط المباشر عن الكيان الإسرائيلي وتشرعن واقعًا جديدًا.
4. البعد العسكري والآثار التشغيلية
- مقتضيات التنفيذ العسكري: تطبيق بند “تجميد الخطوط” يتطلب وقفًا حقيقيًا للعمليات الجوية والبرية والبحرية، بالإضافة إلى تنسيق استخباري مع الجهات الوسيطة، وإجراءات لتحديد مواقع الأسرى، والتحدي العملي هنا هائل: فقدان نقاط الاحتجاز، دمار البنية التحتية، وصعوبة تحديد هوية بعض الأسرى (رفات).
- آليات التفتيش ونزع السلاح: -وهذا طبعًا بند افتراضي في حال موافقة المقاومة عليه- فإن إقامة آليات دولية لتفتيش مواقع ومنشآت أمر معقد ويتطلب موافقة أطراف إقليمية ودولية، بالإضافة إلى ضمانات لمنع استغلال الآليات سياسياً لإضعاف طرف دون آخر.
5. البعد الإنساني والاقتصادي
- تخفيف معاناة قصير الأمد: افتتاح معابر وتدفق مساعدات طبية وغذائية سيقلل المعاناة الفورية، ويمكن أن يُستخدم كدليل على نجاح الخطة إن جرى الالتزام.
- مخاطر تحويل الإعمار لآلية ضاغطة: ربط إعادة الإعمار بشروط أمنية وسياسية قد يجعل السكان وعمليات التعافي رهينة لاعتبارات سياسية ــ ما يعرقل التعافي المستدام ويُعمّق الاعتماد الخارجي.
6. عناصر القوة والضعف في مقاربة الخطة
- قوتها: توفر “ورقة إنسانية” تسمح للإدارة الأميركية بتقديم نفسها كفاعل إيجابي، وتتيح آلية سريعة لحل أزمة الرهائن/الأسرى—وهو عنصر حساس داخليًا داخل الكيان.
- ضعفها: إقحام عناصر تفكيك المقاومة ونزع السلاح سيصطدم برفض شعبي وفصائلي فلسطيني ، كما أن الترتيبات المؤقتة قد تتحول إلى دائمة عبر الضغوط الاقتصادية والسياسية.
7. تحديات التنفيذ والشرط الأساسي للنجاح
إن نجاح الخطة مرهون بثلاثة شروط عملية أساسية:
- قدرة الوسطاء (الولايات المتحدة، مصر، قطر) على إدارة التفاوض والامتثال للمراحل.
- وجود آليات مراقبة فعّالة وحيادية لضمان تنفيذ البنود .
- قدرة الأطراف على الفصل بين الأهداف الإنسانية والسياسية بحيث لا يتحول الدعم لإعادة الإعمار إلى أداة لفرض ترتيبات سياسية أحادية الجانب، وتشير التقارير الأخيرة إلى انخراط الأطراف والوسطاء وإبداء توافق مبدئي على بعض البنود، ولكن ثمة خلافات حقيقية حول البنود الأكثر حساسية (نزع السلاح، شكل الإدارة المؤقتة للقطاع).
مضامين خطة ترامب تُظهر تداخلًا واضحًا بين نوايا إنسانية معلنة وأهداف سياسية وأمنية تستهدف إعادة تعريف البنية السياسية في غزة، وبند الأسرى عملٌ محوري يجعل من إمكانية اتفاق سريع أمرًا ممكنًا على المستوى الإجرائي، لكنه لا يضمن الحلول السياسية العميقة، ويفتح الباب أمام ترتيبات مؤقتة قد تتحول إلى وقائع دائمة إن لم تُراقَب وتُقَيَّد بضمانات تحمي الحقوق الفلسطينية والسيادة السياسية.
رابعًا: القراءة الفلسطينية — الرسمية، الفصائلية، والشعبية
- الموقف الرسمي (السلطة الفلسطينية)
السلطة الفلسطينية اتخذت موقفًا حذرًا يميل إلى الترحيب العرضي بمبادرات وقف النار التي تؤدي إلى خفض الخسائر الإنسانية وإعادة فتح قنوات المساعدات، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون أي مبادرة متسقة مع الطلب الشرعي للحقوق الفلسطينية ومواقف المجلس الوطني والمبادئ المتفق عليها دوليًا (حقوق اللاجئين، القدس، والحدود). في البيانات الرسمية عادة ما وُصِف موقف السلطة بأنه “مرحب لكنه ينتظر التفاصيل” ويُعلن استعدادًا للتعاون الدبلوماسي مع الوسطاء.
موقف السلطة يعكس وضعًا واقعياً من وجهة نظرها: رغبة في إنهاء الحرب، مقابل خوف من أن تتحول أي ترتيبات مؤقتة إلى وقائع تُقصي الدور الفلسطيني السياسي الشرعي، لذا تُفضّل السلطة العمل عبر قنوات دولية وإقليمية للحفاظ على مرجعيتها ولتفادي فرض “حل إداري” يغيّر من طبيعة التمثيل الفلسطيني.
2. الموقف الفصائلي — (حماس و فصائل المقاومة)
أصدرت قيادة حماس ردودًا رسمية تُظهر قبولًا مبدئيًا ببنود تبادل الأسرى والشروط الإنسانية، لكنها ربطت القبول بمنظور أوسع: انسحاب إسرائيلي فعلي من غزة، ضمانات لوقف الحرب، وإشراف فلسطيني على مستقبل إدارة القطاع (أو إدماج إدارة مؤقتة فلسطينية–تكنوقراطية بمعايير محددة)، وأكّدت حماس استعدادها لإطلاق الأسرى (أحياءًا ورفاتًا) وفق معادلات التبادل المطروحة شرط توفر “الشروط الميدانية” لتنفيذ ذلك.
ويجمع موقف حماس يجمع بين قراءة تكتيكية — استثمار بند الأسرى لكسب مكاسب إنسانية وسياسية — وقراءة استراتيجية تدافع عن بقاء مطلب إنهاء الاحتلال وسلطة تمثيلية فلسطينية، والقبول الجزئي أو المشروط يفتح نافذة تفاوضية لكنه لا يعني قبولًا بتفكيك البُنية السياسية أو العسكرية للمقاومة.
3. الموقف الشعبي والحراك المدني
الشارع الفلسطيني يُرحّب جزء واسع منه بأي فرصة لوقف الحرب وإخراج الأسرى والعودة إلى الحد الأدنى من الاستقرار، بينما جزء آخر متشدد يرفض أي حلّ مؤقت قد يؤدي إلى تفويت الحقوق أو تشريع السيطرة الإسرائيلية على الأرض والحدود.
الزخم الشعبي قائم على الحسّ الإنساني (الأسرى والضحايا) وفي الوقت نفسه على خشية شرعنة انتزاع الحقوق عبر ترتيبات مؤقتة، وأي استراتيجية فلسطينية فعّالة يجب أن تراعي هذين البعدين: استخدام قضية الأسرى لمعالجة إنسانية مشروعة، مع ضمان آليات تحفظ الحقوق السياسية والإقليمية.
خامسًا: القراءة الإسرائيلية — الحكومة، المؤسسة العسكرية، والمجتمع
- الموقف الحكومي والسياسي
الحكومة الإسرائيلية تُعرَف بأنها متباينة المواقف: قطاعات ترى في الخطة فرصة لخفض الكلفة البشرية والسياسية لإدارة الأزمة، وقطاعات أخرى تخشى أن تسمح للمقاومة الفلسطينية بالانتعاش، وأكدت تقارير عالمية أن تل أبيب قبلت الخطة أو أبدت مرونة للعمل بها كإطار لوقف مؤقت للأعمال، فيما أبقى بعض القادة تحفظات حول البنود المتعلقة بسحب القوة والضمانات الأمنية.
بالنسبة للقيادة السياسية، الخطة تمثّل فرصة لاحتواء أزمة داخلية (الضغط السياسي والشعبي) وإعادة ترتيب القوات، لكنها تحمل مخاطرة بتقويض ركيزة الردع إذا لم تُرفَق بضمانات أمنية صارمة.
2. الموقف العسكري والأمني
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ترى في أي هدنة فرصة لإعادة تموضع واستعادة قدرات إمداد وإعادة رسم خرائط السيطرة، في المقابل الأجهزة الاستخبارية تحذّر من أن أي ضَعف في الآليات الأمنية او اخضاع المقاومة قد يسمح بإعادة بناء قدراتها، وتفيد تقارير بوجود نقاشات تقنية حول نزع السلاح، ومدى قبول حكومة الاحتلال بمنح أي كيان دولي صلاحيات على الأرض.
الضمانات الأمنية والآليات الميدانية ( قواعد الاشتباك، المراقبة) ستكون مفتاح قبول أو رفض أي بند متعلق بنزع السلاح، والجيش الإسرائيلي سيضغط للحصول على صيغ تضمن استمرار تفوقه وعدم عودة التهديدات الهجومية.
3. الموقف الشعبي الإسرائيلي
الرأي العام الإسرائيلي منقسم: أُسر الجنود والمخطوفين تشكّل ضغطًا هائلاً على الحكومة للمبادرة بصفقة تبادل سريعة؛ في المقابل هناك شريحة تميل إلى موقف أكثر تشددًا خشية من تمكين المقاومة لاحقًا.
والإعلام الإسرائيلي يركّز على الجانب الإنساني لملف الأسرى كما ركّز أيضًا على شروط الضمانات التي تطلبها تل أبيب.
سادسًا: التحليل الاستراتيجي لخطة ترامب 2025 — إدارة أزمة أم فرض تسوية؟
تطرح هذه الورقة السؤال المركزي: هل تهدف الخطة الأميركية–الإسرائيلية إلى إدارة الأزمة فقط، أم أنها محاولة لفرض تسوية سياسية تحت غطاء هدنة؟ التحليل التالي يستند إلى المقاربات الفلسطينية، الإسرائيلية، والدولية، مع رصد السيناريوهات المستقبلية.
- تقييم جوهر الخطة
إدارة الأزمة (الجانب الظاهر)
تهدئة الميدان العسكري ووقف التصعيد يخفف الضغط الإنساني والسياسي على الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين.
- فتح المعابر، إدخال المساعدات، والإفراج عن الأسرى يقدم صورة إنسانية سريعة تعزز شرعية الوساطة الأميركية.
- هذه البنود تجعل من الخطة أداة لحل مؤقت ومباشر للأزمة، دون معالجة القضايا الجوهرية المتعلقة بالحقوق والسيادة.
فرض تسوية (البعد المخفي)
- السيطرة على غزة من خلال ترتيبات مؤقتة، إشراف دولي/إقليمي على إدارة القطاع، ونزع السلاح من المقاومة، جميعها تشير إلى محاولة إعادة هندسة الواقع الفلسطيني دون منح الفلسطينيين أي قوة تفاوضية حقيقية.
- بند الأسرى والاستفادة من المساعدات الإنسانية تُوظف كأداة ضغط لإجبار الأطراف على قبول ترتيبات جزئية، قد تتحول لاحقًا إلى “وقائع ثابتة” على الأرض.
- تعزيز النفوذ الأميركي والإسرائيلي في إعادة ترتيب المراحل السياسية، مع إبقاء الخلافات الكبرى دون حلّ دائم، يفتح الطريق لتكريس وضع جديد في غزة والضفة.
2. السيناريوهات المحتملة
أ) السيناريو الإنساني القصير المدى
- تهدئة فورية، تدفق مساعدات طبية وغذائية، إطلاق أسرى في إطار تبادلات محدودة.
- نتائج إيجابية فورية لكنها محدودة، لا تعالج دوافع الحرب.
ب) السيناريو السياسي المتوسط المدى
- ضغوط على الفلسطينيين لقبول ترتيبات مؤقتة، سواء عبر إشراف وسيط دولي أو شروط إعادة الإعمار.
- إمكانية نشوء “إدارة مؤقتة” للقطاع تفتح الباب لتغيير موازين القوة السياسية داخليًا، مع خطر تطبيع السيطرة الإسرائيلية.
ج) السيناريو الأمني
- أي خرق للهدنة يعيد الحرب بوتيرة أسرع.
- التحديات الأمنية تشمل صواريخ المقاومة، أنفاق هجومية، وخلافات داخلية فلسطينية حول الاستجابة للضغوط.
د) السيناريو الاستراتيجي الطويل المدى
- تثبيت النفوذ الأميركي والإسرائيلي على الأرض دون حل سياسي دائم.
- استمرار هشاشة الموقف الفلسطيني، مع بقاء الأسئلة الكبرى حول قضايا الحقوق والمتطلبات الفلسطينية دون معالجة.
الخلاصـة
تحمل خطة ترامب 2025 طبيعة مزدوجة فمن جهة تعالج الجانب الإنساني بشكل عاجل لإدارة الأزمة، وجانب سياسي يسعى لتثبيت واقع جديد على الأرض، وهكذا يبقى الفلسطينيون أمام تحدٍ مزدوج: الاستفادة من البعد الإنساني للتخفيف من المعاناة، مع رفض أي محاولات لإضعاف السيادة أو الحقوق الأساسية.
ويتطلب النجاح الفلسطيني تكاملاً بين العمل السياسي، الدبلوماسي، الأمني، والإعلامي، مع قدرة على التكيف مع السيناريوهات المختلفة والتصرف بحكمة لحماية مصالح الشعب الفلسطيني.
التوصيـات
- تعزيز الوحدة الوطنية والتنسيق بين حماس والفصائل الأخرى لتقديم موقف موحد، يحمي الحقوق الأساسية ويرفض أي ضغوط لتفكيك البنية السياسية أو العسكرية الفلسطينية.
- العمل الدبلوماسي متعدد المستويات واستخدام المفاوضات الدولية والإقليمية لضمان آليات مراقبة وشفافية في تنفيذ أي بند إنساني أو تبادل أسرى.
- إدارة ملف الأسرى بذكاء وتحويله إلى أداة ضغط دبلوماسي واستراتيجي، مع ضمان التوازن بين الجانب الإنساني والحقوقي، ومراقبة تنفيذ أي صفقة لتجنب استغلالها لفرض ترتيبات سياسية أحادية الجانب.
- التواصل الإعلامي الاستراتيجي وإبراز الموقف الفلسطيني الشرعي عالميًا، مع توضيح أن أي هدنة أو تبادل أسرى يجب أن يكون ضمن إطار حماية الحقوق والسيادة، ومواجهة أي محاولات لتصوير الإدارة المؤقتة أو إعادة الإعمار كحلول سياسية دائمة.
- الاستعداد الأمني والتشغيلي ومتابعة التطورات الميدانية، وضمان قدرة المقاومة على الحفاظ على ردعها المشروع، بما يتوافق مع الشروط الإنسانية والسياسية، وتطوير آليات مراقبة فلسطينية–شعبية للتأكد من التزام الأطراف الأخرى بالشروط المتفق عليها.